صلاح بوسريف يرى أن الأزمة تكمن في “أفلاطونية جديدة”

اندبندنت عربية / علي عطا
يرى صلاح بوسريف أن “أزمة” الشعر في راهن الثقافة العربية نابعة من طبيعة تلقيه، “المنحازة إلى وعي تاريخي يقوم على المقارنة والمشاكلة والمماثلة والمضاهاة”، مما يجعلنا بصدد “أفلاطونية جديدة، بمدينة سعيدة لا مكان فيها، ليس للشعراء وحدهم، بل الفلاسفة أيضاً”، على حد تعبيره.
يذهب بوسريف في هذا الكتاب إلى أن أخطر ما وضع الشعر في حرج القراءة والتلقي هو ما يسميه بحداثة التقليد، أي التقليد الذي التبس بالحداثة، أو هو حداثة استقرار، وليست حداثة صيرورة واستمرار. وهو يتفق مع أن الصوت في الشعر هو عنصر كتابي بحسب بول فاليري “وهو ما نلتقطه ليس بالأذن وحدها بل بكل الحواس، بتداعيها وتجاوبها، كما هجس بذلك شارل بودلير”. يتألف الكتاب (174 صفحة من القطع المتوسط) من مقدمة تليها ستة أقسام. وفي المقدمة يرى أن لا شاعر يظن أن الشعر في أزمة، وإلا كان التجديد والابتداع والابتكار في الشعر توقف وامتنع، ونكص الشعراء ليعودوا القهقرى لما يضمن وجود “المواد التراثية” في شعرهم، وفق عبارة يوري لوتمان.
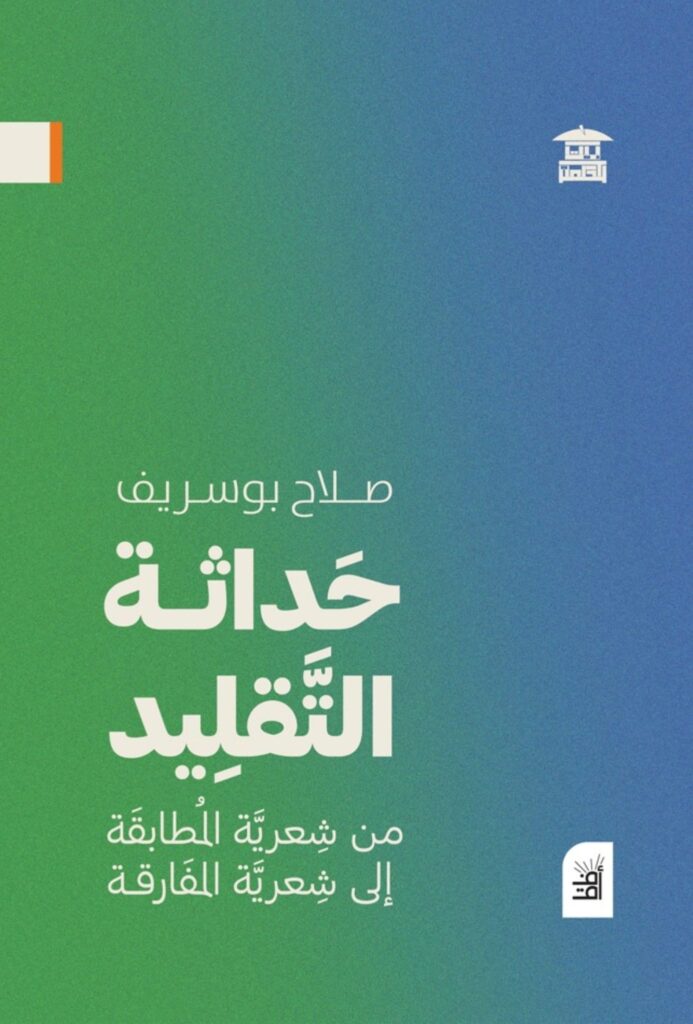
الكتاب النقدي (دا رالحكمة)
وأول أقسام الكتاب عنوانه “مهمة الشعر” ويخلص إلى أن تلك المهمة هي نفسها مهمة الفكر، هي الفكر في سياق وجود في الجمال، وهذا الجمال الذي نجده في الرؤية وفي الموقف وفي طبيعة اللغة وما تلتبس به من دوال لم يعُد الحرف أو الكلمة، هما ما يبتنيان الشعر، أو هما الشعر، كما توهمته البيانات الشعرية التي اعتبرت اللغة في الشعر هي كل شيء على رغم ذهاب بعضها إلى الخط، أو “الكتابة” التي حين نقرأ معناها سنجدها في التدوين، أو الكتابة الإملائية للصوت، ليصير الحرف حاملاً للصوت وليس جسداً مسكوناً بروحه هو، روح الكتابة التي كانت أكبر ثورة عرفها العقل البشري في وجوده على الأرض.
ماهية الشعر
ويرى بوسريف أن تجربة بول فاليري تمثل في سياقها الشعري – النظري، أفقاً شعرياً وفكرياً، بل فنياً جمالياً، كان يميل إلى المباغتة وهي تجربة محكومة بالإحداث، بما هو طارئ أو بذلك الـ Poiesis كما يمثله الإغريق وكان وعياً عندهم بالاختلاف والاختلاق، وسماه هايدغر “الرؤى الكونية” التي من غير اللائق أن نؤثِر فيها رؤية على أخرى. ويمكن اعتبار أن هذا هو “ما نعتز به عند الشعراء المؤسسين مثل مالارميه”. هؤلاء، وفق بوسريف، “استطاعوا وضع الشعر في أفق اللانهائي”.
وينقل عن عبدالرحمن بدوي قوله “الشعر يبعث على ظهور ما هو خيالي وما هو حلم في مواجهة الواقع الصاخب الملموس الذي نعتقد أنه منزلنا الأليف”، بيد أن الواقع هو ما يقوله الشاعر وما يفترض وجوده، كما قالت بانثيا في رواية “أنبادوقليس” لهيلدرلين “أن يكون المرء ذاته هذه هي الحياة ولسنا نحن غير حلم بها”، وهكذا فإنه وفق ما أورده بدوي في تقديمه لكتاب مارتن هايدغر “ما الفلسفة؟ وما الميتافيزيقا؟ هيلدرلن وماهية الشعر”، تبدو تلك الماهية “وكأنها تترنح في ظهورها وشكلها الخارجي، ومع ذلك فهي راسخة في حقيقتها” (ص 36).

الشاعر والناقد المغربي صلاح بو سريف (صفحة الشاعر – فيسبوك)
المشكلة اليوم، بحسب بوسريف، هي أننا لا نأخذ الشعر مأخذ الجد ونعتبره كلاماً غامضاً من دون التساؤل في شأن الغموض، ونعتبره مجرد موسيقى في حال وعينا بإيقاعاته من دون السؤال عن دور الموسيقى في الوجود، أو الموسيقى نفسها كـ “فكر” أو كـ “فلسفة”، وما يكون في الموسيقى نفسها من “تداخل الأساليب”. وما يربك فيها “الحكم والفهم لدى المتلقي في مسألة تحديد ماهية الإبداع والحكم ليس في مضمار العزف أو التأليف الموسيقي، وإنما كذلك في الفلسفة والفكر والموسيقى بوصفهما رافدين للمعرفة والنقد، بحسب نصير شمة في كتابه “الأسلوبية موسيقياً”.
الصور المضللة
ومن ثم فإن عزلة الشعر في زمننا،هي عزلة النص – الكتاب وهي عزلة العمل الشعري، عزلة الجوهر لأن التقنية اكتفت بالسطح والمظهر وحولت الشعر إلى ثرثرة، أو إلى نوع من “عدم الكفاءة الشعرية”، كما يقول ياكبسون، أو إلى لغة ليس الشاعر من يكتبها، بل هي من تكتبه، وهذا ما سماه هايدغر “الانكتاب” وانساق وراءه الشعراء والنقاد من دون وعي المفهوم، مما جعل اللغة “مادة” وليست روحاً وجوهراً، أو ذاتاً بالأحرى، إذا نحن استدعينا هيغل، أي اللغة في لا نهائيتها، كما يقول موريس بلانشو، وفي “تاريخها غير المكتمل ونسقها غير المغلق”.
القسم الثاني من الكتاب عنوانه “الصور المضللة” ويحيل إلى ذريعة أفلاطون في طرد الشعراء من مدينته الفاضلة، وهي أنهم انحرفوا عن الفكر أو حرّفوه وانزاحوا عنه بإغراء تلك الصور المضللة. ويقول بوسريف إنه من بين المعاصرين من المفكرين يمكن استحضار علاقة محمد عابد الجابري بالشعر، فقد رآه مع مفكرين آخرين نقيضاً للعقل. ويرد بوسريف على ذلك بالقول إن الشعر هو تذكير للعقل بأساسه التخييلي وبطفولته وبما كان عليه، أو ما يمده بالقدرة على الخلق والابتداع.
وفي القسم الثالث وعنوانه “التفكير بالشعر”، ومما خلص إليه هو أن الحوار والسرد والاسترجاع وتداخل الأصوات والضمائر والشخوص والأقنعة، بكل ما تمثله من انتماءات أنطولوجية وما تحتمله من شر أو خير، وبما تشارك فيه من أحداث ووقائع، أو تناقضات ومفارقات، “هي كلها في أساس الشعر، أو في أساس البناء الشعري الملحمي، باعتبار الشعر الذي تعتبر “القصيدة” واحدة من أنواعه، هو جامع أنواع، وهذا هو المعنى الذي تقوم عليه حداثة الكتابة، بكل ما في النص أو العمل الشعري من دوال” (ص 74). وهذه هي ميزة لم نقدرها، يقول بوسريف، ونحن ننتقل من الشعر إلى “النثر” الذي نقابله خطأ بالشعر، لا بـ “النظم” سواء في الثقافة العربية أو في الثقافة الغربية، بل النثر كان يراه فلوبير ما “تكون به الجملة النثرية كمثل بيت شعري ممتاز لا بديل له، موقّع كأحسن ما يكون الإيقاع”.
ويرى بوسريف في هذا السياق أن روايتي “البحث عن الزمن المفقود” لبروست و”يوليسيس” لجيمس جويس تدخلان في “زمن الشعر” وفي سياقه الشعري الجمالي وفي بناء الشعر نفسه، لا في “زمن الرواية”، “بهذا النوع من التعميم غير الدقيق، وغير الموفق إطلاقاً” (ص 77). وينطبق الأمر ذاته على نصوص مسرحية كبرى مثل “فاوست” لغوته و”في انتظار غودو” لصامويل بيكيت، وبعض مسرحيات سعد الله ونوس لجهة “طبيعة البناء والفكر والسياق الشعري الجمالي لهذه الأعمال وما تجره من خلفها من مشكلات ومن استعصاء في قراءتها وفي مشاهدتها وفي طبيعة الاختراقات الموجودة فيها، قياساً بما اعتاد عليه الذوق العام وما قرأناه ودرسناه في المدارس والجامعات، لما فيها من كثافة وغموض وتشابك وتركيب”.
ويضيف بوسريف “إذا كنا هنا ندافع عن التفكير بالشعر في الشعر، أو التفكير شعرياً في الشعر، فهذا سيفرض علينا أن نقرأ الشعر شعرياً، من دون أن ننأى به عن تفكيره، أو عن كتابته التي كانت تفكيراً في الشعر بالشعر”. وهكذا يصل بوسريف إلى خلاصة مفادها بأن مشكلة الشعر هي مع قارئه ومع نقاده ومع المؤسسات التي تعمل على تدريسه وترويجه، فهي تبعده من زمنه ومن سياقاته الفنية الجمالية ومن راهنه، لتعود به للحظة ما في الماضي، وليس كل الماضي الذي ظهر فيه شعر آخر برؤية أخرى ورأي آخر ينتقد بعض هذا الماضي كما عند أبي نواس وعند أبي تمام وعند أبي العتاهية الذي اعتبر نفسه أكبر من العروض وعينه كانت على الإيقاع حتى وهو لم يبُح به، أو يعِه بالمعنى نفسه الذي نتصوره به اليوم.
مأزق المتلقي
ويبدأ بوسريف القسم الرابع من الكتاب وعنوانه “مأزق القصيدة” بالتشديد على أن لا أحد يجادل في أن “القصيدة”هي الشكل المثالي، أو هي الخطاطة المثالية في الثقافة العربية القديمة التي كرسها “زمن التدوين” وحسم بناءها وأمر تسميتها وما تكون عليه من قوانين. ومع ذلك حدث خروج عليه قديماً وحديثاً، حتى وصلنا إلى قصيدة النثر التي يفضل بوسريف تسميتها “الشعر المنثور” أو “النص الشعري” بترجمة عبدالعزيز المقالح. والمطاردة مستمرة، ويرى بوسريف أنها تزداد شراسة وتعقداً، “وتنتقل كعدوى تمس الجميع، بما في ذلك الشعراء الذين باتوا يهاجرون إلى الرواية، بحثاً عن ملاجئ يحمون أنفسهم فيها من هذه المطاردات” (ص 135). ويضيف في هذا الصدد “لعل تكريس النمط، أو البحث عن سلف في الشعر المعاصر وفي شعر الحداثة هو أحد مظاهر هذا اللاشعور الماضوي في فكرنا وثقافتنا العربيين”. ويختم بوسريف كتابه بفصل عنوانه “مكانة الشعر” وفيه يؤكد أن مأزق القارئ أو المتلقي مع الشعر الحداثي المعاصر، وهو المأزق نفسه مع النقد ومع من يبحثون في الشعر، فهم في تلقيهم العمل الشعري، لديهم أفق انتظار، إذا تكسر أو خيب توقعاتهم، فهذا معناه أن هذا العمل ليس شعراً لأن هذا الأفق هو معيار وأفق قانون، وليس أفق احتمالات” (ص 168).
المزيد عن: الشعر العربيالقصيدةالمعايير النقديةحرية الكتابةالحداثةالفكرالفلسفةصلاح بو سريفالمغرب




